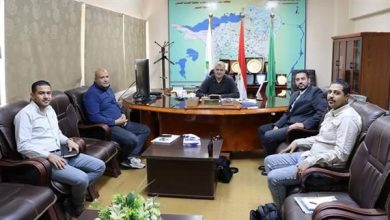زوبعة السائرين نحو السعادة

قلم: إيمان الجمعة.
في منتصف مكان ألا مكان، في منتصف إنكسار قلم وشقلبة حرف، في منتصف غياهب الحزن وصعود الألم، في منتصف الشهيق وامتناع الزفير، في منتصف قهقهات باكية، في منتصف رقصة نبضة قلب ثم بَتر الساق، في منتصف النصف من الأشياء، حيث تقع في زوبعة بعثرة عائمة بداخلك، و لربما سؤال نصفه ميت، يأخذك لتجري مع أفكارك، ثم تقف كذلك في المنتصف، وكأنك تجري وسط مطر ينهمر ثم تدرك إنك مفلس دون مظلة، ولربما في منتصف حيرتك كذلك تسأل سؤال شبه غير منطقي، أين أنا وما أنا؟ أو قد تجد نفسك تلتقط القلق من صوت رعد يربك انصاف حياتك المهزوزة، لتتمرد على اعتياديتك بالسكون أو بالصراخ أو نصف ابتسامة، لينتهي بك الأمر بمواجهة نفسك ماذا تريد و هل أنت سعيد الآن أم تمثل السعادة؟
حثيثا و بعد كل التيه الذي خذلك تتوه فيه، و هو ليس بالأمر الغريب أن يستحوذ على خلجات الإنسان، لتجد نفسك تسير؛ تبحث عن حفنة سعادة تدغدغ قلبك أو تدهش نصف يومك، فأحيانا كثيرة يعيش الإنسان عمره باضطراب باحث عن السعادة، و لربما يموت ولا يصل إلى حيث مراده، ولكن حتمية سؤال هل الوصول إلى السعادة حقيقة هو ما يؤرق الباحث عنها؟
و الحقيقة التي لا تخفى أنه أختلف الإنسان في تعبيره عن مفهوم السعادة، ولربما إشكالية الوصول لمفهومها ليست محدودة، فنجد علم النفس عرّف السعادة بشكل عام على أنها “نتائج لشعور الفرد أو وصوله لدرجة الرضا عن حياته أو جودة حياته”، أو أنه ذلك “الشعور السار المتكرر لتلك المشاعر والانفعالات الصادرة من الكثير من الفرح والانبساط”، و لازال هذا توضيح و وجهة نظر علم النفس وهي إن السعادة مفهوم يتحدد بطبيعة الفرد وحالته، أي هو من يقرر سعادته من تعاسته.
و من منظور آخر صاغوا الفلاسفة أيضا العديد من الشروح لمفهوم السعادة، كأفلاطون رأى إن السعادة ما هي إلا “فضائل النفس، التي شملت الحكمة والشجاعة وغيرها منوّها إلى عدم قدرة الإنسان الوصول إلى كامل السعادة إلا عند انتقاله إلى الحياة الأخرى”، في حين اعتبر أرسطو إن السعادة “نعمة من نعم الباري الذي يهبها للناس، محددا تشكلها في الصحة، وتوفر المال، والنجاح في العمل، وتحقق الأهداف، بالإضافة لسلامة العقل والتمتع بالسمعة الحسنة بين الناس في المجتمع”، و يحضرني كذلك ما قاله لونوار في هذا الشأن فقد ربط السعادة “بإيجاد معنى لحياة حياتنا”، يشير في معنى كلامه إلى حقيقة واحدة تساوي في المقابل حقيقة توقظه على سعادة تصبغ كل وجوده ومن حوله بها، ولكن يعتبر هذا ليس شيء محدد بعينه أو ينطبق في المقابل على الجميع، لأنه مؤكد أن معنى الحياة كذلك يختلف من فرد إلى آخر.
أما في قوائم معايير القوانين والتصنيفات العالمية فقد زج فيها عنوان يعلمنا عن مصارد و خطوات السعادة، وتفرعت كذلك إلى أن تكون تحت بنود كالسعادة الشخصية و السعادة الاجتماعية وكذلك النفسية، ثم تدرجت إلى أن تنقسم سعادة مؤقتة أو طويلة المدى، نعم فالأولى التي غالبا ما يشعر فيها الفرد لبعض الوقت وتنتهي بلحظتها، فما كانت إلا لأنها ترتبط بموقف أو حدث سار عابر، و يعود بعدها الفرد إلى حالته الانفعالية العادية، المرتبطة بكينونته الداخلية وشخصيته. أما الأخرى طويلة المدى وهي التي غالبية الناس تسعى محاولة البحث عنها والوصول إليها، كونها تدوم لفترة زمنية طويلة، وتعطي الفرد شعورا مستمرا بالسعادة، لينطلق بكل رحابة نحو الحياة.
ولكن بعيدا عن اللحظات الحقيقية السعيدة، فقد تكون لحظات متلحفة بقناع البهجة، من ثم تكبر فتتحول في كثير من الأحيان إلى بيئة تجعل الفرد يعي و يرى هامش هوسه، و صخب جريه العبثي حول هامش الحياة. فعلى الرغم من تعدد مصادر البحث في توصيل كيفية عيش السعادة، إلا أنه لازال الإنسان يبحث عن السعادة، و لا زال هناك بشر ينهي حياته!
وعن طبيعة أن لكل وجهة نظر رأي مخالف يصدمها، فقد ظهر الكثير ممن يهاجم و ينتقد تلك النظريات والمفاهيم، ومنهم ميشيل دي مونتين الذي وجه نقد للفلاسفة الذين وصفوا ورسموا وصفة ثابتة ومجهزة للجميع لتحقيق سعادتهم، كما أقترح “أن يبحث كل فرد عن السعادة الخاصة به، والمتوافقة مع طبيعته”.
ففي عالم النظريات والقوانين والأنظمة الذي يرسم لك حتى كيف تبتسم أو يعلمك كيف تنام، وقد تكون كل تلك الآراء والنظريات صحيحة إلا أنه هناك بعض القوانين تجعلك تقع في إرتباك، فمنذ عمر وجود الإنسان وهو الذي أخذ على عاتقه أن يؤطر نفسه بقوانين وشروط لكيفية عيش الحياة، إلى أن جعل منها أنظمة كقوالب ذات مقاسات معينة إن لم تكن ضيقة، و مفاهيم فضفاضة في حين أخر، والتي جعلت من الجميع إن يعتقد اعتقاد جازم أنه لابد عليه من أن يتقولب خلالها ليكون جاهز لحياة اعتيادية، تمكنه من التعايش مع زوابع عصره وإلا التحق في ركب التعساء، فتزداد وتتفاقم مشكلته وهو يثبت طريقته الغير اعتيادية في عيش السعادة.
و الغريب أن أغلب الذين يملكون الكثير من تلك التي تدعى مظاهر السعادة، تراهم كذلك تائهين في زوابع الحياة، باحثين عن السعادة الكاملة، ليشتبك عليهم الأمر وهم سائرين نحوها أن يعيشوا خلال السير إليها!
فإذًا يمكننا القول كنتيجة عقلانية إن السعادة حالة نسبية عند كل فرد، كما هي نظرته للحياة، بل هي قرار تتخذه من خلال منظورك لطبع الحياة.
فهناك من يجدها في قداسة صلاة، وهناك من يعتقد أنه سيجدها حين ينهي حياته ظنا منه أنه ينهي شتاته، ومنهم من يراها في المتعة و انشراح الصدر أو الرضا بكل شيء، وآخر يلبسها كقناع بنصف حزن وسط صخب ضحكاته، والكثير منهم يجري خلف من يلبس عباءة المدرب ذو الطاقية الإيجابية، متوهم أنه سينقذه من دوامة البحث ليصل به إلى قمة السعادة إلا محدودة، ليصور له أنه بأمكانه أن يمسك بالنعيم، كأن يمسك عصا سحرية بمقدورها أن تتحكم في مجرى حياته بالكامل، يوهمه ببضع كلمات يُطلب منه تكرارها كالبغبغاء، ولكن هي تجارة تجعلها تسحب مالك من جيبك بيدك، -على كلا ليس هذا موضوعنا الآن فالحديث في هذا المضمار يطول-.
وسواء تحدثنا أو عرضنا كل السبل إلى السعادة إلا إن فقراء السعادة يزدادون يوم بعد يوم، والرغبة فيهم للحصول عليها كظهر أعوج كلما عدلته مال ليسقط صاحبه على الأرض، أ لربما بقي علينا أن نعرف ما كنة تلك الحالة التي يريد الإنسان الوصول إليها؟ أو ما هو الشيء الذي يثير تلك الذات لتشعر بكامل السعادة؟
ولكن هل نحن بحاجة لنستنزف كل حياتنا بتلك الطرق الشبه مستحيلة والقوانين الفضفاضة للحصول على السعادة الكاملة؟
أسئلة تساوي الجواب عنها عمر الإنسان الباحث عن السعادة، و لكن بطريقة أو بأخرى حيث ألا اكسجين، ألا ضوء، ألا رؤية، حيث ألا طريق للوصول، حيث ممر نصفه عقل والآخر عبث، حيث ربطة عنق على عنق ثوب، حيث عباءة على “مكياج” أحمر فاقع، تتذبذب النفس الإنسانية بين أطراف الحياة و بين نصف سعادة دون هوادة، ظنا منها أن تجد خلالها شعور النعيم، أو علّها تملأ جوفها بكأس السعادة.
ولكن ما توصلنا إليه هذه الزوابع إلا لنتيجة واحدة، وهي إن إتاحة ذاتك وكينونتك للشعور بالسعادة لهو أهم من أن تجعل سعادتك هدفا بعيد المنال لحيث ألا عودة.
ثم حيث السائرون، حيث زوابع السعادة ، حيث عندك أنت، أنت هل تعيش السعادة الآن؟